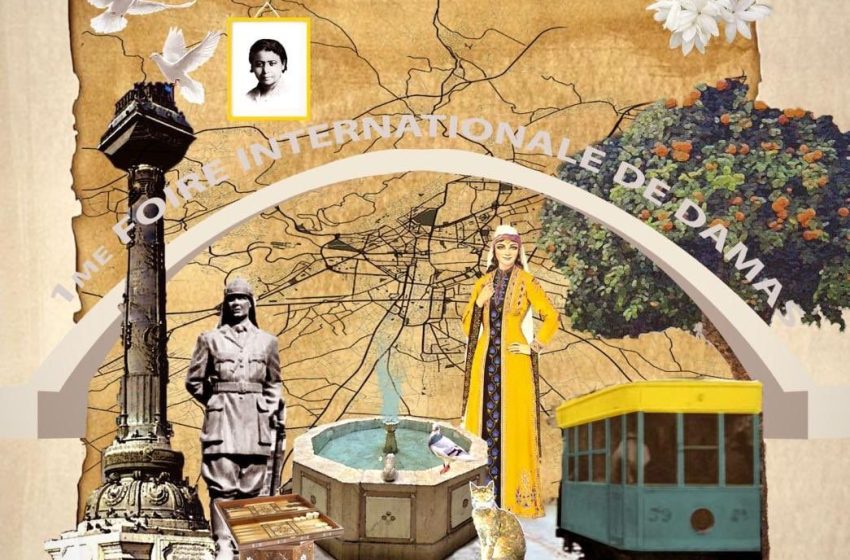
تزوير تاريخ سوريا
كحال الكثير من الباحثين والكتّاب المتابعين للشأن السوري، لم أصدّق للوهلة الأولى الأنباء التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وتحدّثت عن تعديل منهاج التاريخ في الكتب المدرسية السورية يما يخدم الأجندات السياسية والأيديولوجية للسلطة الحالية، وصولاً إلى وصف كتاب التاريخ للصف الثامن الإعدادي، لشهداء أيار الذين شنقهم جمال باشا السفاح بـ«المتآمرين» على الدولة العثمانية وبـ«العملاء لإنكلترا وفرنسا».
كان عليّ العودة
وزارة التربية السورية وتحميل كتب التاريخ المتاحة للطلاب، لأتأكد من صحة الخبر ولأكتشف أن الشريف حسين بن علي الهاشمي والأمير فيصل بن حسين الهاشمي قد جُرِّدا في هذا الكتاب من كلّ ألقابهما وورد اسماهُما من دون أي لقب بما فيه لقب «أشراف مكة» الذي توارثاه أباً عن جدّ، فسُمِّيا بحسين بن علي وفيصل بن الحسين. وفي المقابل، احتفظ الجنرال التركي جمال باشا السفاح بلقب الباشوية إلى جانب اسمه في الكتاب، وحُذِف لقب السفاح الذي لقّبه به أحرار العرب والأرمن لما اقترفته يداه من جرائم بحقّهم. كما تمّ تبديل تسمية «الثورة العربية الكبرى»، وهو الاسم الذي أطلقه العرب والسوريون في ذلك الزمان على ثورتهم وأعاد استخدامه الكثير من المؤرّخين، بتسمية «تمرّد» المتعارف عليها تركياً.
تفاجأت أيضاً أنّ كتاب التاريخ للثالث الثانوي الأدبي (بكالوريا) والمخصّص للتاريخ الحديث للبلدان العربية، بما فيها تاريخ سوريا الذي خُصِّصت عدّة فصول له، لا يأتي أبداً على ذكر كلمات من مثل الديموقراطية أو الانتخابات أو المجلس النيابي، رغم حضورها في مجرى الأحداث التاريخية السورية! ويغفل عن ذكر اللحظات التأسيسية المصيرية في تاريخ الشعب السوري بعد الاستقلال، خصوصاً تلك المرتبطة بانتخابات المجلس التأسيسي في العام 1950 والذي صاغ دستور 1950، وانتخابات 1954 التي تمت وفقاً لهذا الدستور وانبثق عنها أفضل مجلس نيابي تمثيلاً لإرادة الشعب السوري.
قد يظن البعض أنّ هذه التعديلات أتت من قبل بعض التكنوقراط في وزارة التربية المنتمين لهيئة تحرير الشام، والذين ظنوا أن هذه الصفحات من التاريخ السوري يمكن لها أن تثير المشاكل والتوترات مع الجارة تركيا أو مع المملكة العربية السعودية، فاجتهدوا بملء إرادتهم لإدخال هذه التغييرات المجحفة في كتابة التاريخ السوري من دون العودة لمراجعهم العليا. لكنّ حساسية رجال السلطة الحالية لكلمات من مثل الديموقراطية والمجلس النيابي والدستور والإرادة الشعبية، وصدور مرسوم رئاسي، واضح وصريح، يحدد الأعياد الرسمية للجمهورية السورية مع إغفال تامّ لعيد شهداء السادس من أيار الذين أعدمهم جمال باشا السفاح والذي كان مثبتاً منذ فجر الاستقلال عيداً للشهداء في الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية، أوضح بما لا يدع مجالاً للشك أنّ هذه التوجهات في إعادة كتابة تاريخ سوريا هي توجهات ترتبط بأعلى مراكز القرار في السلطة الحالية، وتصيب معنى الكيان السوري وأحداثه التأسيسية الكبرى ومشروعيته التاريخية.
شهداء أيار كأوّل فعل تأسيسي
رأى الكيان السوري النور، للمرّة الأولى، مع الثورة العربية الكبرى والمؤتمر السوري وإعلان الاستقلال في 8 آذار من العام 1920، الذي توّج الأمير فيصل ملكاً على سوريا، بوصفها مملكة ديموقراطية نيابية مدنية. وإذا كانت هذه المملكة الوليدة لم تعمّر طويلاً وتمّ القضاء عليها بقوة السلاح بعد أن دخلت قوات الجنرال غورو دمشق على أشلاء ودماء شهداء ميسلون وفي مقدمتهم وزير الدفاع يوسف العظمة، فإن الحركة الوطنية السورية في نضالها الطويل ضد الانتداب الفرنسي، لم تتخلَّ يوماً عن مطالبتها بوطن سوري قائم بذاته ضمن دولة مستقلة وذات سيادة، من دون أن تضع ذلك في تعارض مع القضية العربية التي بدأت بالتشكل في المشرق العربي مع انحلال الإمبراطورية العثمانية ونكس الحلفاء بوعدهم للشريف حسين وولادة الدول الوطنية وفرض الهيمنة الاستعمارية على منطقتنا. هذه القضية العربية التي، وعلى عكس ما يظن الكثيرون اليوم، لم يضع رجالاتها الانتماء الوطني في تعارض مع البعد العربي، ولم يسعوا الى تفكيك الكيانات الوطنية التي نشأت في اعقاب الحرب العالمية الأولى، بقدر ما كانوا معنيين باستعادة التعاون والتنسيق وحرية التحرك فيما بين هذه البلدان، وإزالة الحدود الجمركية والاقتصادية والثقافية التي فرضها المستعمر عنوة فيما بينها.
لا نبالغ في شيء إذا قلنا إن رمزية إعدام شهداء أيار في ساحة المرجة في دمشق وساحة البرج في بيروت على يد جمال باشا السفاح، تكاد تكون واحدة من أهمّ اللحظات التأسيسية الأولى لولادة الكيانين السوري واللبناني، ليس فقط لأنها أعلنت أفول الرابطة العثمانية على يد الطورانيين الأتراك، ولكن لأنها عمّدت بالدم، إذا صح القول، بداية نزوع الوطنيين السوريين واللبنانيين إلى البحث عن وطن جديد وهوية مغايرة ومواطنة حديثة بعيداً عن الإمبراطورية العثمانية التي تفككت في البلقان وانهارت على يد الجنرالات الأتراك في أعقاب الحرب العالمية الأولى لصالح وطن قومي للأتراك وللأتراك فقط.
لذلك لم يكن غريباً أن تكرّس السرديات الوطنية التي تشكلت مع فجر الاستقلال في كل من سوريا ولبنان مكاناً خاصاً ومتميزاً لشهداء أيار وأن تسمى الساحتان الأهم في كل من بيروت ودمشق باسمهم وأن يكرَّس تاريخ إعدامهم في 6 أيار 1916 عيداً وطنياً للشهداء في كلا البلدين.
الأمير فيصل وشهداء أيار
خلال تاريخ سوريا الحديث، ورغم كل الانقلابات وتغيير أنظمة الحكم التي طرأت على البلد، لم تتجرأ أي سلطة سورية على المساس برمزية عيد الشهداء بوصفه عيداً وطنياً يخصّ كل السوريين، كما ظلت ألوان العلم السوري تستوحي ألوان علم الثورة العربية.
لا بل إن استعادة ذكرى شهداء أيار، كانت حاضرة دائماً في النصوص التأسيسية للكيان السوري بدءاً من إعلان الاستقلال في 8 آذار 1920 الذي أفسح المجال واسعاً في نصه للتذكير بشهداء السادس من أيار، وهو النص الذي أقرّه المؤتمر السوري وألقاه عزة دروزه نيابة عن الملك فيصل من على شرفة البلدية في ساحة المرجة/ الشهداء، وشكل منذ ذلك اليوم المرجع الرئيس لكل الدساتير التي توالت على الجمهورية السورية.
من هنا لم يكن غريباً أن يستعيد الرئيس شكري القوتلي، من جديد ذكرى شهداء أيار بعد 30 عاماً من رحليهم، في خطاب الاستقلال الذي ألقاه في الاحتفال الأول بعيد الجلاء من على شرفة السرايا في 17 نيسان 1946 غداة جلاء القوات الفرنسية من سوريا على بعد خطوات من ساحة الشهداء حيث علقت ذات يوم المشانق لأحرار العرب، وممّا قاله: لم تكد تنشب الحرب العالمية الأولى حتى تلظى الروح القومي، ورأينا السجون والمنافي تكتظ بالأحرار، ورأينا كيف يكون التنكيل بالأبرار. وهناك على بعد أمتار من هذا المكان، استفاقت دمشق ذات صباح على مشهد صفوف مختارة من رجالات العرب علقوا من المشانق.
لم يكتفِ القوتلي في خطاب الاستقلال التاريخي بتوجيه التحية لأرواح شهداء أيار، ولكنه استعاد إعلان الاستقلال للمؤتمر السوري الأول في العام 1920 كحدث تأسيسي تلاه معركة ميسلون واستشهاد يوسف العظمة، كما وجه التحية إلى سلطان باشا الأطرش بوصفه قائداً للثورة السورية الكبرى، وذكر بالاسم إبراهيم هنانو في جبل الزاوية والشيخ صالح العلي في جبال العلويين، هؤلاء القادة الذين يجري تغييبهم اليوم من سرديات بعض أبواق السلطة الحالية بسبب انتمائهم الطائفي والعرقي.
كما لم يستطع القوتلي في ذلك الخطاب إلا أن يستذكر الأمير فيصل بن الحسين الهاشمي، لا بوصفه ملك العراق المتوفي، بل لكونه الحاكم الأول الشرعي للكيان السوري مسمّياً إياه «فيصل الخالد»، بالرغم من ابتعاد القوتلي سياسياً آنذاك عن المحور الهاشمي في العراق والأردن وقربه من السعودية ومصر الملك فؤاد.
يمكننا المغامرة والقول هنا إنّ مكانة فيصل بن الحسين في الوجدان الشامي وبين قادة الحركة الوطنية السورية من الشهبندر إلى القوتلي، ومن هاشم الأتاسي إلى فارس الخوري، ومن سلطان باشا الأطرش إلى الشيخ رشيد رضا، كانت وما زالت مكانةً خاصة، لارتباطها بمعركة السوريين نحو الاستقلال وبنضالهم من أجل تأسيس نظام دستوري نيابي ديموقراطي منتخب تحت راية الدين لله والوطن للجميع، بالتوافق مع الأمير فيصل حيناً ورغماً عنه في أحيان كثيرة. فهذه التجربة، على قصرها، وهي التي لم تمتدّ سوى عامين، طبعت وجدان السوريين وظلت تذكرهم بحلمهم المَوؤُود في نيل استقلالهم وإقامة نظامهم البرلماني المنتخب، قبل أن تفرض عليهم القوى الاستعمارية نظام الانتداب المجحف.
ويكفي أن نستذكر اليوم في حاضرنا الراهن (حيث يتجنب المسؤولون الحكوميون ذكر كلمة الديموقراطية، وحيث تغيب حقوق المواطنة المتساوية ويعطى لرئيس السلطة الانتقالية صلاحيات غير مقيدة، وحيث تُزوَّر الإرادة الشعبية بحجج واهية ويستعاض عن المجلس التأسيسي المنتخب والممثل للإرادة الشعبية بمجلس شعب معيّن تعييناً ستُطبخ فيه القوانين لاحقاً ويكتب الدستور في لجان مفتقدة لأي مشروعية شعبية) يكفي أن نستذكر الواقعة التي تسميها إليزابيث تومبسون باللحظة الأسطورية في التاريخ السوري في كتابها «كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب»، وهي تخص النقاش الذي دار بين الشيخ رشيد رضا والملك فيصل الذي رفض في البداية قرار المؤتمر السوري بأن تمثل الحكومة أمامه بوصفه ممثلاً للإرادة الشعبية وتنال الثقة منه لا من الملك.
فعندما سأل الملك فيصل الشيخ رشيد رضا رأيه في سبل الخروج من هذا المأزق، قال رضا ناصحًا: رأيي أنّه لا يمكن الرجوع عنه بعد وقوعه، فلا بدّ من تنفيذه.
أُحبط فيصل وألحّ قائلًا: لا أقبل أن أُعطي السلطة لهذا المؤتمر. إنّه ليس بمجلس نيابي.
ردّ عليه رضا: بل هو أعظم من مجلس نيابي، إنّ هذا المؤتمر جمعية تأسيسية.
قال فيصل: أنا الذي أوجدتُه، فلا أعطيه هذا الحقّ الذي يعرقل عمل الحكومة.
ردّ رضا بحسم: بل هو الذي أوجدك. أنت كنت قبله قائد جيش الشرق التابع للورد ألنبي، فجعلك هذا المؤتمر ملكًا لسوريا. إنّه يمثّل السلطة العليا لأنه يمثّل الأمّة. إنّ هذا يستند إلى دينك الإسلام وكلّ القوانين الحديثة.
دموع القوتلي
إذا كان خطاب القوتلي في العام 1946 الذي أتينا على ذكره أعلاه، احتفالاً بجلاء القوات الفرنسية، بمثابة لحظة تأسيسية هامة في تاريخ الجمهورية السورية، فلا شك أن خطابه أمام مجلس النواب السوري بعد 12 عاماً في 1958 والذي أعلن فيه قيام الوحدة بين مصر وسوريا وترشيح الرئيس جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية العربية المتحدة، أتى بدوره كلحظة تأسيسية ثانية في تاريخ الجمهورية السورية، ولكن هذه المرة ليعلن نهاية فصل من تاريخها وبداية فصل آخر لا نزال نعيش مفاعيله ومخرجاته إلى اليوم.
لقد قرّرت السلطة الحالية، بعيداً عن أي استشارة شعبية أو برلمانية، إلغاء عيد الشهداء من أجندة الأعياد الوطنية، رغم أن تاريخ سوريا الحديث مليء باللحظات التاريخية التي تبيّن مركزية هذه المناسبة ودورها في بناء الهوية الوطنية. فالرئيس القوتلي، وكما كان الحال في خطابه يوم الاستقلال، عاد في يوم إعلان الوحدة مع مصر في 5 شباط من العام 1958 ليستعيد ذكرى شهداء أيار قائلاً من تحت قبة البرلمان لقد أردنا الثورة العربية خلال الحرب الكونية الأولى، وفي أعقابها، ثورة في سبيل الحرية والوحدة فنصبت لنا أعواد المشانق، وتهافت عليها الأحرار وهم ينشدون أناشيد الحرية والنصر. وكان نداء هذه الأرض العربية المطهرة بدماء الرواد الأوائل، إيذانا بتفجير الثورة على أربعمائة عام من حكم الإرهاب والإفناء.
تورد جريدة الأهرام على صفحتها الأخيرة ربورتاجاً صحفياً لمراسلها في دمشق ينقل في هذا اليوم المشهود، بالتفاصيل وبالصور، مجريات هذه الجلسة التاريخية والدراماتيكية، كون الرئيس القوتلي أتى للمجلس النيابي وبحضور أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد في دمشق، ليعلن للجميع نهاية مهامّهم ونهاية مجلسهم ونهاية تعدّد الأحزاب- كما اشترط عبد الناصر- ونهاية دوره كرئيس للجمهورية ونهاية الجمهورية السورية نفسها بصيغتها البرلمانية الرئاسية.
وما زاد من دراماتيكية هذه اللحظة أن الرئيس القوتلي تبنّى القضية العربية منذ أن كان مناضلاً في «الجمعية العربية الفتاة» إبان العهد العثماني، وحُكِمَ عليه بالإعدام إلى جانب رفاقه من شهداء أيار لكنه نجا بأعجوبة في اللحظة الأخيرة ولم يلقَ ذات المصير، وقُدِّر له أن يكون رئيسًا منتخبًا للجمهورية ليعلن نيل سوريا استقلالها. وها هوذا، في عهده الثاني، رئيساً يدشِّن عهد الوحدة التي لطالما حلم به، هو ورفاقه، لكنه أتى هذه المرة بالشكل الاندماجي المركزي الذي ارتآه عبد الناصر، والذي كان السبب الرئيس لمقتل هذه التجربة.
يصل الرئيس القوتلي في خطابه أمام نواب الأمّة إلى تلك الفقرة المؤثرة التي يستذكر فيها رفاقه من شهداء أيار عندما يقول معتذرًا منهم ولهم: أرجو، أيها الإخوان الأعزاء، أن أكون باعتباركم، وباعتبار هذا الشعب العربي العظيم الذي يشرفني أن أنتسب إليه، مواطنًا عاديًّا – كما أرجو أن أكون، باعتباركم واعتباره، قد أديت واجبي نحو بلادي وأمتي، وكنت جديرًا بالثقة التي أوليتموني إياها خلال هذه الحقبة من الزمن العصيب. فإنْ قصَّرت، فعذري أنني عملت بصبر وإيمان وصدق وإخلاص، وإنْ أخطأت، فعذري أنني إنسان، وليس الإنسان بمعصوم. وإنْ فاتني شرفُ الاستشهاد ولم أكن بجوار الخالدين من أحرار هذه الأمة، فأمام الله أشهد أنني لم أجنِّب نفسي خطرًا، ولم أوفِّرها عن شهادة.
نقرأ في ربورتاج صحيفة الأهرام كيف ارتجف صوت القوتلي فجأةً من على منبر المجلس النيابي وخانته دموعُه وهو يستذكر رفاقه من شهداء أيار. خلفه كان جالساً على منصة رئاسة المجلس أكرم الحوراني الذي لم يعد قادرًا على حبس دموعه، وعلى صفحة الأهرام الأخيرة، نرى صورة رئيس الوزراء صبري العسلي وهو يرفع عن عينيه نظارتيه السميكتين ويمسح دموعه. وينقل مراسل الأهرام كيف بكى العديدُ من النواب، وكيف بكت زوجة القوتلي وابنته.
بالرغم من العواطف الجياشة التي تفيض في مناسبات مصيرية كهذه، يحقّ للمرء أن يسأل قادة سوريا الجدد وكَتَبة تاريخها الذين لا ينفكّون يفصّلونه ويحوّرونه على مقاس جيرانهم الأقوياء وحماتهم الإقليميين، ألا يخجلون من أرواح شهداء أيار ودماء شهداء ميسلون، ألا يخجلون من تضحيات عبد الرحمن الشهبندر ونضالات الأمير فيصل لكي تنال سوريا استقلالها؟ ألا يخجلون من دموع القوتلي وعذابات الكثيرين غيره من السياسيين والمناضلين والمناضلات السوريات الذين بذلوا الغالي والرخيص لكي تبقى سوريا حرة مستقلة لكل أبنائها؟ ألا يخجلون من دماء شهداء الثورة السورية العظيمة، ثورة الربيع العربي، ثورة الحرية والكرامة، الذين قدموا مئات الألوف من الشهداء لكي تصبح سوريا وطناً حرّاً نعيش فيه متساوين بكرامة، ولا نموت فيه مسحوقين بمذلّة؟
بقلم:محمد علي الأتاسي




